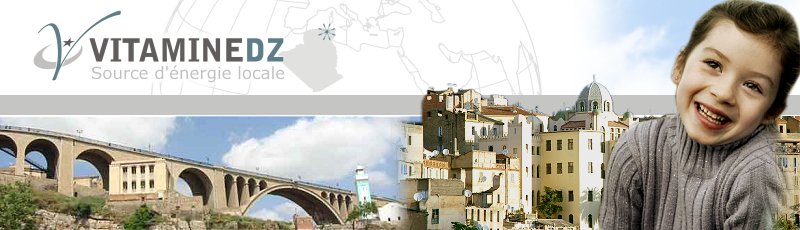
العثمانيون ابتدعوا لقب "الشيخ" ولهذه الأسباب يغيب الصوت المؤنث مختصون يتحدثون عن “طابوهات” المالوف… النساء واليهود والشيوخ

يرى المختصون بأن غياب العنصر النسوي في المالوف يعتبر إحدى المميزات المدرسة القسنطينة في الغناء التي أثرت فيها البيئة الاجتماعية والعادات والتقاليد، حيث يقول الباحث عبد الماليك مرواني إن خصوصيات المدرسة القسنطينية قائمة على أصناف من الأزجال ييني فيها اللحن تداولا بين المغني والآلات، بحيث يسمح للإيقاع بمرافقة صوت المغني تداولا يظهر فيه إيقاع الآلات بوضوح. وهناك نوع خاص من الأزجال يسمى البوري وهو زجل خاص بقسنطينة وحدها فقط ولا نجده في غيرها من المدارس، حيث قال عنه الشيوخ: “لو عرفوا دخلات وخرجات الزجل لغناوه البنوتات”، بمعنى أنه مستعص على النساء وليست لهن القدرة على أدائه. وأضاف مرواني قائلا إن هذا النوع كان يصعب حتى على الرجال، بحيث كان في قسنطينة لا يلقب بالشيخ إلا من تمكن من هذا النوع من الأزجال، وتكمن الصعوبة فيه أن أغصانها، أي “الأزجل”، طويلة بالكيلومترات ويصعب ترتيب الكلمات فيها.
وفي السياق ذاته، أرجع مرواني غياب العنصر النسوي في المالوف القسنطيني إلى خصوصية المدينة كبيئة محافظة بحيث كانت العائلات في السابق ترفض تزويج بناتها لمن يمتهن الغناء، فما بالك أن تمتهن المرأة نفسها الغناء.. وهذا لأن الغناء كان في السابق في نظر المجتمع قرينا بمجلس الخمر واللهو، الذي تترفع عنه العائلات. وبقي بحسب المتحدث هذا التقليد معمولا به في مدرسة المالوف القسنطيني، بحيث لا نجد في هذه المدرسة الكثير من الأصوات النسائية مقارنة بالمدرسة العاصمية أو مدرسة الحوزي التلمساني. ورغم هذا تبقى بعض الاستثناءات القليلة في هذا المدرسة، تمكنت من كسر الطابو، على غرار زهور الفرقاني والمطربة ثريا بلبيض، لكنها تبقى قليلة جدا.
وكشف عبد الماليك مرواني أن هناك محاولات اليوم لتجاوز وتكسير هذا الطابو، حيث تستعد المطربة دنيا الجزائرية لإصدار عمل تؤدي فيه الزجل. وأشار مرواني إلى أن هذا يدخل في إطار المحاولات الرامية إلى إقناع العائلات بتجاوز التقاليد المتوارثة والسماح لبناتها بممارسة هذا الفن، خاصة ضمن الجمعيات التي لها مهمة تربوية ثقافية.
ويربط الباحث حسين بخوش بين غياب أو تغيب النساء في مدرسة المالوف القسنطيني والتقاليد الاجتماعية المتوارثة في مدينة محافظة بقيت سارية المفعول إلى اليوم، رغم وجود محاولات لخرق هذا الحظر على غرار تلك التي قام بها الأستاذ زرابي خالد، منذ خمس سنوات، لإطلاق فرقة نسوية تعزف المالوف. وتشكلت فعلا هذه الفرقة وصعدت على ركح أحد المهرجانات، لكنها لم تلبث أن اندثرت ولم تستمر. وكانت أيضا فرقة أخرى أطلقها الطاهر بشطانجي باقتراح دائما من الأستاذ زرابي، ضمن جمعية الانشراح، ولكنها أيضا مبادرة لم تستمر ولم تعمر طويلا. وهناك أيضا فرقة جمعية حمودي بن حمود، نجم قرطبة، لكنها مثل سابقاتها لم تعمر طويلا.
ويعتقد الأستاذ بخوش أن الحظر الاجتماعي على الصوت النسوي في مدرسة القسنطينية هو الذي يعرقل استمرار العنصر النسوي في الذهاب بعيدا في احتراف الغناء والعزف في المالوف، فبمجرد أن تتزوج المرأة تتفرغ لبيتها وأبنائها ويصبح من العيب أن تحترف الغناء.
وبالإضافة إلى مكانة وتواجد العنصر النسوي، تثار عادة مسألة مساهمة اليهود في هذا التراث، بحيث يحاول البعض نسبة أصالة هذه المدرسة إلى اليهود. ويرى عبد الماليك مرواني بأن ثمة مغالطات كبيرة يسوقها اللوبي اليهودي والصهيوني خاصة، الغرض منه الاستيلاء على تراث الشعوب، حيث يرمي البعض وراء هذه المغالطات إلى نسبة المالوف والتراث الأندلسي لليهود وحدهم دون سواهم. ويؤكد مرواني في هذا الصدد أن البحوث في قائمة شعراء الزجل والموشحات الأندلسية، نجد اسما واحدا، هو ابن سهل الإشبيلي الإسرائيلي، وعندما نقرأ الترجمات التي أرخت له نجد أنه ختم حفظ القرآن وعمره 12 عاما، حيث يذكر ابن سعيد الذي كتب المقتطف الذي استعان به ابن خلدون في كتابة المقدمة يقول إنه عندما التقى ابن سهل وسأله هل اعتنقت الإسلام أم بقيت على يهوديتك أجابه: “لله ما استتر وللناس ما ظهر”.
نفس الرأي تقاسمه تقريبا الدكتور عبد الله حمادي مع عبد الماليك مرواني، في وجود محاولات للاستيلاء والاستفراد بهذا التراث عن طريق تضخيم دور اليهود فيه، ويضيف حمادي أن اليهود تقاسموا العزف والغناء مع ساكنة قسنطينة من المسلمين، حيث كان اليهود يمارسون التجارة والحرف التقليدية بقسنطينة، وبرزت فيهم مهارات في الطرز وصناعة الحلي وتقاسموا فضاءات الفنادق التي كانت في السابق ميزة قسنطينية مع المسلمين، وهذا مكن اليهود من التواصل الفني مع أنغام المالوف، وصاروا يمارسون العزف والغناء في طقوسهم الدينية، وبرزت منهم أسماء عدة في هذا الفن، على غرار ناتان بنطري، وعيرود صانع العيدان المشهور بقسنطنة، واغنايسية سيلفيا وريمون ليريس، وهو الذي تعلم على شيوخ المالوف في فندق جبدو بزنقة الرصيف.
ويعتبر عبد الله حمادي أن تضخيم دور اليهود في المالوف القسنطيني ليس “البهتان” أو البدعة الوحيدة التي لحقت بهذا التراث، حيث يعتبر المتحدث أن كلمة شيخ مثلا لا وجود لها في تاريخ المالوف، لكنها بدعة دخيلة فلم يسبق حسب حمادي أن أطلق الأندلسيون لقب شيخ على مطرب أو مغن، وبقيت الكلمة مقدسة تطلق حصرا على العلماء والأئمة، لكنها صارت في ما بعد تقليدا ظهر مع الوجود العثماني- حيث جاء ليُضمر شيئا ما يخشى محترفو غناء المالوف أو الشعبي إظهاره؛ لكون غنائهم المعروف بالشعبي والمالوف والأندلسي يحوي الكثير في مضامينه من الخلاعة والظرف في قصائدهم ذات النزعة الإباحية وحتّى الجنسية. وحتّى لا ينفضح شأن المغنين لهذا النّوع من الطرب الماجن والخليع في مُحتواه ومغزاه، أضفوا ما يشبه الهالة على كبار المغنين منهم هيبة “المشيخة”، ليتمسّحوا بمدلولها الدّيني وإخفاء ما يمكن أن يعلق بهم من الشُبهات التي يمكن أن تلحق بأساتذتهم في هذا الشأن الملفت للانتباه.. فابتكروا هذا النّوع من التستّر حتّى لا ينفضح أمرهم، وخاصة أنّهم كانوا يعلمون أنّ شهادة أحدهم كانت لا تُقبل في المحاكم الشرعية الإسلامية بحكم أنّهم يعتبرون من الفُسّاق”.
تاريخ الإضافة : 27/07/2023
مضاف من طرف : patrimoinealgerie
صاحب المقال : زهية منصر
المصدر : echoroukonline.com