
سيدي محمد الهاشي تلمسان
عدد القراءات : 69هذا القسم مخصص لـ سيدي محمد الهاشي إذا كان لديكم معلومات أو تعليقات حول هذا الموضوع، لا تترددوا في إبدائها. هذ الفضاء مفتوح لحرية التعبير ، ولكن بهدف إيجابي شكرا لكم على المشاركة
- قراءة التعاليق
ولد سماحة الأستاذ المرشد الكبير سيدي محمد بن الهاشمي قدس الله روحه من أبوين صالحين، كلاهما من آل بيت النبوة، يرجع نسبهما إِلى الحسن بن علي رضي الله عنهما، يوم السبت 22 شوال 1298هـ في مدينة سبدة التابعة لمدينة تلمسان، وهي من أشهر المدن الجزائرية. وكان والده من علمائها وقاضياً فيها، فلما توفي ترك أولاداً صغاراً، والشيخ أكبرهم سناً.
بقي الشيخ مدة من الزمن ملازماً للعلماء، قد انتظم في سلكهم جاداً في الازدياد من العلم، ثم هاجر مع شيخه محمد بن يَلِّس إِلى بلاد الشام فاراً من ظلم الاستعمار الإِفرنسي، الذي منع الشعب الجزائري من حضور حلقات العلماء وتوجيههم. وكانت هجرتهما في 20 رمضان سنة 1329هـ عن طريق طنجة ومرسيليا، متوجهين إِلى بلاد الشام. فمكثا في دمشق أياماً قلائل، وعمِلَتْ الحكومة التركية آنذاك على تفريق جميع المغاربة الجزائريين، وكان نصيبه رحمه الله تعالى أن ذهب إِلى تركيا وأقام في أضنة، وبقي شيخه ابن يَلِّس في دمشق. وعاد بعد سنتين إِلى دمشق ؛ فالتقى بشيخه ابن يَلِّس وَصَحبه ولازَمه.
وفي بلاد الشام تابع أخذ العلم عن أكابر علمائها. ومن أشهرهم المحدِّث الكبير بدر الدين الحَسَني، والشيخ أمين سويد، والشيخ جعفر الكتاني، والشيخ نجيب كيوان، والشيخ توفيق الأيوبي، والشيخ محمود العطار وأخذ عنه علم أُصول الفقه، والشيخ محمد بن يوسف المعروف بالكافي وأخذ عنه الفقه المالكي، وقد أجازه أشياخه بالعلوم العقلية والنقلية.
أما من ناحية التصوف فقد أذن له شيخه محمدبن يَلِّس بالورد العام لما رأى من تفوقه على تلامذته، من حيث العلمُ والمعرفةُ والنصحُ لهم وخدمتُهم. ولما قدم المرشد الكبير أحمد بن مصطفى العلوي من الجزائر لأداء فريضة الحج ؛ نزل في دمشق بعد وفاة سيدي محمد بن يَلِّس سنة 1350هـ، وأذن له بالورد الخاص [تلقين الاسم الأعظم] والإِرشاد العام.
أخلاقه وسيرته:
كان رحمه الله تعالى متخلقاً بأخلاق النبي (صلى الله عليه وسلم)، متابعاً له في جميع أقواله وأحواله وأخلاقه وأفعاله، فقد نال الوراثة الكاملة عن الرسول (صلى الله عليه وسلم).
وكان متواضعاً حتى اشتهر بذلك ولم يسبقه أحد من رجال عصره في تواضعه.
وكان يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه. دخل عليه رجل فقبَّل يد الشيخ رحمه الله تعالى؛ وأراد الشيخ أن يقبل يده، فامتنع الرجل عن ذلك وقال: أستغفرُ الله يا سيدي أنا لست أهلاً لذلك، أنا أَقبل رجلكم. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: إِذا قَبَّلت رِجْلَنَا فنحن نقبل رجلَكم.
وكان يحب أن يخدم إِخوانه بنفسه، فيأتي الزائر، ويأتي التلميذ فيبيت عنده فيقدِّم له الطعام، ويحمل له الفراش مع ضعف جسمه. وكم جئناه في منتصف الليل، وطرقنا بابه، فيفتح الباب وهو بثيابه التي يقابل بها الناس، كأنه جندي مستعد. فما رأيناه في ثوب نوم أبداً.
وكان حليماً لا يغضب إِلا لله. حَدَث أن جاءه رجل من دمشق إِلى بيته وأخذ يتهجم عليه، ويتهكم به، ويتكلم بكلمات يقشعر لها جلد المسلم ؛ ولكن الشيخ رضي الله عنه لم يزد على قوله له: الله يجزيك الخير، إِنك تُبين عيوبنا، وسوف نترك ذلك ونتحلى بالأخلاق الفاضلة. وما أن طال المقام بالرجل إِلا وأقبل على الشيخ، يقبل قدميه ويديه، ويطلب منه المعذرة.
وكان كريماً لا يرد سائلاً. وكم رأينا أشخاصاً يأتون إِليه فيعطيهم ويكرمهم، ولاسيما في مواسم الخير ؛ حيث يأتي الناس لبيته، وترى موائد الطعام يأتيها الناس أفواجاً أفواجاً يأكلون منها، ولا تزال ابتسامته في وجهه، وقد بلغ من كرمه أنه بنى داره التي في حي المهاجرين بدمشق قسمين: قسم لأهله، وقسم لتلاميذه ومريديه.
وكان من صفاته رضي الله عنه واسع الصدر وتحمل المشقة والتوجيه، وشدة الصبر مع بشاشة الوجه ؛ حتى إِني استغربت مرة صبره فقال لي: يا سيدي! مشربُنَا هذا جمالي. وكان يأتي إِليه الرجل العاصي فلا يرى إِلا البشاشة من وجهه وسعة الصدر، وكم تاب على يديه عصاة منحرفون، فانقلبوا بفضل صحبته مؤمنين عارفين بالله تعالى.
حَدَث أنه كان سائراً في الطريق بعد انتهاء الدرس، فمر به سكران ؛ فما كان من الشيخ رحمه الله تعالى إِلا أن أزال الغبار عن وجهه، ودعا له ونصحه، وفي اليوم الثاني كان ذلك السكران أول رجل يحضر درس الشيخ، وتاب بعد ذلك وحسنتْ توبته.
وكان رحمه الله تعالى يهتم بأحوال المسلمين ويتألم لما يصيبهم، وكان يحضر جمعية العلماء التي تقام في الجامع الأموي، يبحث في أمور المسلمين ويحذِّر من تفرقتهم، وقد طبع رسالة تبين سبب التفرقة وضررها، وفائدة الاجتماع على الله والاعتصام بحبل الله سماها: القول الفصل القويم في بيان المراد من وصية الحكيم.
وكان رحمه الله تعالى يكره الاستعمار بكل أساليبه، ويبحث في توجيهه عن مدى صلة الحوادث مع الاستعمار وكيفية الخلاص من ذلك. ولما نَدبتْ الحكومة الشعب إِلى التدرُّب على الرماية، ونظَّمت المقاومة الشعبية، سارع الشيخ لتسجيل اسمه بالمقاومة الشعبية، فكان يتدرب على أنواع الأسلحة مع ضعف جسمه ونحوله وكبر سنه. وبهذا ضرب للشعب المثل الأعلى لقوة الإِيمان والعقيدة والجهاد في سبيل الله، وذكَّرنا بِمَنْ قبله من المرشدين الكُمَّل الذين جاهدوا الاستعمار وحاربوه ؛ أمثال عمر المختار والسنوسي وعبد القادر الجزائري. وما المجاهدون الذين قاموا في المغرب، لإِخراج الاستعمار وأذنابهم إِلا الصوفية.
وكان رحمه الله تعالى حسن السيرة والمعاملة، مما جعل الناس، يُقبلون عليه ويأخذون عنه التصوف الحقيقي، حتى قيل: لم يشتهر الهاشمي بعلمه مع كونه عالماً، ولم يشتهر بكراماته مع أن له كرامات كثيرة، ولكنه اشتهر بأخلاقه، وتواضعه، ومعرفته بالله تعالى.
وكان رحمه الله تعالى إِذا حضرْتَ مجلسه، شعرت كأنك في روضة من رياض الجنة ؛ لأن مجلسه ليس فيه ما يشوبه من المكدرات والمنكرات. فكان رحمه الله تعالى يتحاشى أن يُذكر في حضرته رجل من المسلمين وينقص. ولا يحب أن يذكر في مجلسه الفساق وغيرهم، ويقول: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة.
وبقي رحمه الله تعالى دائباً في جهاده مستقيماً في توجيهه للمسلمين وإِخراجهم مما وقعوا فيه من الضلال والزيغ. فقد كانت حلقاته العلمية متوالية من الصباح حتى المساء ؛ ولاسيما علم التوحيد الذي هو من أُصول الدين، فيبيِّنَ العقائد الفاسدة والإِلحادية، مع بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، والرجوع إِلى الله تعالى؛ والتعلق به دون سواه.
نشاطه في الدعوة والإِرشاد:
كان بيته قبلة للعلماء والمتعلمين والزوار، لا يضجر من مقابلتهم، ويقيم ـ مع ضعف جسمه ـ حلقات منظمة دورية للعلم والذكر في المساجد والبيوت، ويطوف في مساجد دمشق، يجمع الناس على العلم وذكر الله والصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وسلم). ولم يزل مثابراً على همته ونشاطه ودعوته حتى أيامه الأخيرة.
تتلْمذَ عليه نخبةٌ طيبةٌ صالحة من العلماء وطلاب العلم، ومن مختلف طبقات الأمة يهتدون بإِرشاداته، ويغترفون من علومه، ويقتبسون من إِيمانه ومعارفه الذوقية، ويرجعون إِليه في أُمورهم.
وقد أذن للمستفيدين منهم بالدعوة والإِرشاد، وبذا انتشرت هذه الطاقة الروحية الكبرى في دمشق وحلب، وفي مختلف المدن السورية والبلدان الإِسلامية.
وقد أخذ التصوف عن سيدي الهاشمي رحمه الله تعالى كثيرٌ من العلماء وغيرهم لا يعلم عددهم إِلا الله.
وهكذا قضى الشيخ الهاشمي حياته في جهاد وتعليم، يربي النفوس، ويزكي القلوب الراغبة في التعرف على مولاها، لا يعتريه ملل ولا كسل. واستقامته على شريعة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قولاً وعملاً وحالاً، ووصيتُه في آخر حياته: عليكم بالكتاب والسنة، تشهد له بكمال وراثته.
وهكذا رحل الشيخ الكبير إِلى رضوان الله تعالى وقربه يوم الثلاثاء 12 من رجب 1381هـ الموافق 19 كانون الأول 1961م، وصُلي عليه بالجامع الأموي، ثم شيعتْه دمشق تحمله على الأكف إِلى مقبرة الدحداح، حيث وُورِي مثواه، وهو معروف ومُزَار. ولئن وارى القبرُ جسدَه الطاهر الكريم، فما وارى علمه وفضله ومعارفه وما أسدى للناس من معروف وإِحسان، فلِمثْل هذا فليعملِ العاملون. وهذا من بعض سيرته الكريمة، وما قدمناه غيضٌ من فيضٍ ونقطة من بحر، وإِلا فسيرة العارفين منطوية في تلامذتهم، ومن أين للإِنسان أن يحيط بما تكنه صدورُهم وأسرارهم ؟
وفي مثله قال القائل:
إِنْ تــســــــلْ أيـــنقــبــورُالـعــظــمــا فــعـــلـى الأفــواه أو في الأنــفـــس
وبمثل هذه الشخصيات الحية نقتدي وبمثلهم نتشبَّه.
فـتـشــبَّــهـُواإِن لم تـكـونـوا مـثلَهــم إِنَّ التـشـــبُّــهَ بالـكــرامِ فــــلاحُ
وقد قيل:
مــوتُ الــتــقــي حــيــاةٌ لا انــقــطـاعَ لهــا قدْ مات قومٌ وهمْ في الناس أحياءُ
mortdada adib yamane - kenadsa - الجزائر
28/05/2011 - 15278
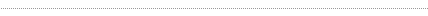
mortdada adib yamane - kenadsa - الجزائر
28/05/2011 - 15278
- تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
- مقالات : سيدي محمد الهاشي
- صور : سيدي محمد الهاشي
- إعلانات : سيدي محمد الهاشي
- دليل المؤسسات : سيدي محمد الهاشي
- مقاطع فيديو : سيدي محمد الهاشي
- مقاطع موسيقية : سيدي محمد الهاشي
- روابط : سيدي محمد الهاشي